Marocain-XF
عضو فريق العمل
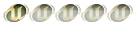

عدد الرسائل : 1913
العمر : 68
Localisation : الرباط
. : 
اوسمة العضو (ة) : 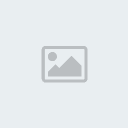
النقاط المكتسبة من طرف العضو : 8785
خاصية الشكر : 12
تاريخ التسجيل : 30/05/2009
بطاقة الشخصية
royal: 1
 |  موضوع: منح الشاعر"محمود درويش جائزة الأركانة بالمغرب موضوع: منح الشاعر"محمود درويش جائزة الأركانة بالمغرب  الجمعة 16 أبريل 2010, 13:18 الجمعة 16 أبريل 2010, 13:18 | |
| منح الشاعر"محمود درويش جائزة الأركانة بالمغرب منح الشاعر"محمود درويش جائزة الأركانة العالمية للشعر للعام 2009م: سعدي يوسف يضيء مسرح محمد الخامس، ونصير شمّة يصل الرباط ببغداد عبر تاريخٍ من الحبّ والشعر
1 سعدي يوسف: لكأنّني الآن أسمع رفيف أجنحة 24 تشرين الأول (اكتوبر) لن يكون، من الآن، عادياً في ذاكرة الشعر والشعراء. ذلك التاريخ البعيد الذي حدّده محمود درويش، قبل أن يرحل بأيّامٍ، موعداً لاستلام جائزة الأركانة التي منحها له بيت الشعر بالمغرب للعام 2008 م. لكنّ الشاعر الفلسطيني عاجله / عالجه الموت، فلم يحضر. حضر، بدلاً عنه، شقيقه أحمد ومُحبّوه ووارثو أسرار شعريّته، مأخوذين بروحه العظيمة التي خيّمت على فضاء مسرح محمد الخامس، وهو الذي كان أثيراً لديه في كلّ لقاء شعريّ ـ روحيّ جمعه بجمهوره المتعاظم في المغرب. ربّما، لهذا السبب، صعد الشاعر سعدي يوسف خشبة المسرح، لاستلام الجائزة نفسها هذا العام، وهو يترنّح مأخوذاً بروح رفيقه ومُصغياً إلى هَيْنماتٍ من نشيدٍ لا يزال. قال سعدي، بنبرة حزْنٍ آسر: "أوجِّه رفيفاً من الرُّوح إلى محمود درويش". وفي إشارةٍ إلى اللقاء الذي جمعه بالشاعر محمود درويش عام 2003م، قال سعدي: "في هذه اللحظة، أشعر أنّنا لا زلنا معاً بهذا المكان الأثير لدينا"، وأضاف "اللحظة شديدة القصر والإرهاف، لكنّها الكفيلة بالتغيير الأعمق في ذواتنا. لكأنّني الآن أسمع رفيف أجنحة. إنّ طاقة الشعر لا تفنى. الشعر هو أغنية، هو أغنية كما قال محمود درويش". وأخبر سعدي جمهور المسرح أنّه عائد للتوّ من الصين التي ترجمت إلى لغتها مختاراتٍ من شعره لم يفكر حتّى في مراجعتها، لأنّ له ثقة كبيرة في عربية الصينيّين الذين يكنّون كل الاحترام للشعراء العرب، مثلما يعترفون لبيت الشعر المغربي بالفضل في عودة أخيهم الغريب الشاعر الصيني بيي ضاو من مقامه الطويل في الولايات المتحدة إلى وطنه الصّين، بعد أن مُنح جائزة الأركانة في دورتها الأولى للعام 2002م. ثمّ أنشد الشاعر سعدي يوسف، خلال الحفل الذي قدّمته الشاعرة وداد بنموسى وحضره وزراء وسفراء ومثقّفون وأدباء، قصائده (أيام العمل السري)، و(قصيدة يائسة)، و(إلى سركون بولص)، و("نابل" في الشتاء) التي يقول منها:تتجمّعُ الأمطارُ في كانون ...
في الكورنيشِ ، صيّادونَ لم يَحْنوا الجباهَ لسطوةِ الأنواءِ ، بضعةُ فِتْيَةٍ تاهوا
مع الفتَياتِ . في الكورنيشِ ذكرى أو رسائلُ . كان كِشْكُ مثلّجاتٍ يحتمي بالريحِ .
سوف نكون، في مَغْنىً، هنا ! 2. خداري، حميش، صبحي والوهايبي: الكلمات الّتي تجب وكانت سبقت طلّة سعدي على جمهور المسرح كلماتٌ في حقّ المحتفى به وجائزته المستحقّة لم تخْلُ من روح الدّعابة، في البدء، وجّه الشاعر نجيب خداري، رئيس بيت الشعر في المغرب، "تحية للصانع الماهر الأكثر انتباها إلى العابر"، وقال: "نعتز، عميق الاعتزاز، بفوز شاعر عربي رائد كبير هو الشاعر العراقي سعدي يوسف بجائزة الأركانة لسنة 2009. وإذا كانت اعتبارات الإنجاز الشعري الباذخ، في مسيرة سعدي يوسف الطويلة الدائبة المتجددة، مما لا يجهله المهتمون بالمشهد الشعري العربي العالمي، ومما يبوئه عظيم التكريم والاحتفاء، داخل الوطن العربي وخارجه؛ فإنّ هناك اعتبارات تجعل المغاربة أكثر سعادة بذهاب الأركانة إلى سعدي يوسف، تتمثل في صداقته العميقة للمغرب، ولشعرائه وأدبائه وفنانيه ومثقفيه". وزاد: "على كل حال، نعتبر أنّ من رسائل جائزة الأركانة، ومن مهام بيت الشعر في المغرب، تأكيد ضرورة الإنصات المرهف إلى الشعرية العربية، من جاهليّتها إلى الآن، ترجمة وتداولاً واحتفاء، داخل البلاد العربية، وفي كل بلاد العالم". وألفت الحضور إلى "أنّ هناك ظلماً آخر نعانيه هو سياسات حكوماتنا العربية التي تضع الهم الثقافي في أسفل اهتماماتها وميزانياتها. ولكن أبشع أنواع الظلم الذي يلحق بثقافتنا وإبداعنا هو ما يتنزل علينا من خلفية الصراع العربي الإسرائيلي. وهي الخلفية ذاتها التي أضاعت علينا فرصة كانت متاحة قبل أيام لتبوئ كرسي إدارة اليونيسكو". أما الكاتب والروائي بنسالم حميش، وزير الثقافة، فقد حيّا، في كلمة له بالمناسبة، سعدي يوسف يُهنّئه بالجائزة: "سعديْك سعديْك يا أخي سعدي بجائزة الأركانة التي شرفت بك"، وذكّره بصداقة ريتسوس ومحبّته، وما قاله الشاعر سان جون بيرس في أمثاله: "إنّ الشاعر من يكسر، لحسابنا، سُنّة التعوُّد". ولم تخْلُ كلمة حميش من نقد الراهن الثقافي المغربي، عندما دعا إلى الكفّ عن الحروب الثقافية التي لا تخدم أحداً، وإلى تربية النشء على قراءة الشعر وتذوّقه وحفظ ذاكرته من جهته، أشار الكاتب السوري صبحي حديدي، رئيس لجنة التحكيم، إلى أن اجتماع لجنة التحكيم لم يكن بالشكل المتعارف عليه، "فقامة سعدي يوسف كانت شاخصة أمامنا منذ البداية، وكانت قصيدته تثير الإعجاب والإجماع بيننا. لم يطرح أحدٌ إسماً غيره". وأوضح أنّ الذي يلفته في شاعرٍ كبيرٍ مثل سعدي يوسف أمران: شاعر تفعيلة يواصل عناده ومغامرة كتابته بسيولة فائقة. تلك السيولة التعبيريّة التي تضيء لغته وإيقاعه وصوره في تناوله للتفاصيل اليومية، وتجعل منه الأكثر تأثيراً في جيلٍ كبير من شعراء العربية اليوم، بما في ذلك شعراء قصيدة النثر. لم يزل سعدي يوسف مُخْلصاً لانتمائه السياسي والإيديولوجية والأخلاقي، ولم يُلْحق ذلك أذىً بقصيدته، لأنّه منحازٌ إلى الخير والكرامة الإنسانية، وإلى حرّية القصيدة وقيمة الفنّ. فيما لفت الشاعر التونسي منصف الوهايبي، عضو اللجنة، إلى أنّ سعدي يوسف يكتب قصيدته بمفرده، وهو يعود بها من العالم إلى بيته في سلّة، واجداً لها ذلك الوسيط الشعري الذي يصل بين الفعل الفنّي واليومي، ويستثمر الرواية والفنون التشكيلية. إنّ الأمر يتعلّق، وفق تعبيره، بـ"جماليّات المبذول" التي تغنم من اليومي نبض الحياة. وزاد الوهايبي إن قصيدته تُعقد على التكثيف اللغوي، ممّا يتولَّى معه الاقتصاد في العبارة والزهد في تسمية التفاصيل. وهل نصّ سعدي غير لغةٍ مقتصدة تقول اليومي، وتقمّش الأحداث والوقائع بتمثُّلٍ لغويّ أكثر تكثيفاً، ومهما اتّسعت القماشة فهي محدودة ! 3 . نصير شمّة: العود العربي وما يصنع ! وتُوِّج الحفل، الذي شدّ أنفاس الجمهور لنحو ثلاث ساعاتٍ، بمعزوفات الفنان والموسيقار العراقي نصير شمّة الذي حيّا ابن بلده، بطريقته الخاصّة. تحيّة الغريب للغريب. قدَّم شمّة، سليل مدرسة العود العربي العظيمة ومُحييها، سبع معزوفاتٍ موسيقيةٍ امتزج فيها الشعر العربي القديم بالحديث، وعبق بغداد بندى الأندلس، والمقام العربي بالفلامنكوالإسباني. من (حوار بين المتنبي والسياب)، مروراً بـ(إشراق) من مقام كورد، و(غارسيا لوركا) التي ألفها في العام 2000 بغرناطة، وأهداها إلى شاعرها لوركا، و(تنويعات) استوحى لحونها من كلاسيكيّات التراث العربي كـ "بعيد عنك" لأم كلثوم و"يا ما للشام" لصباح فخري، و(بغداد كما تحب)، و(بين دجلة وسعدي يوسف) التي أهداها إلى الشاعر المحتفى به، وانتهاءً بمعزوفة يُطلقها لأوّل مرة، جعلها عربون حبّ من العراق للمغرب، وبالمثل. لقد أطلق شمّة أوتار عوده، وهو يجول في العصور والمقامات المختلفة، تصدح طليقةً في فضاءات التاريخ والثقافة، وتتكلّم السحر والغرابة. كان لموسيقاه البديعة حضورٌ طاغٍ بادٍ من العيون المشدوهة التي تشعُّ في ظلام المسرح، وتُرغم حتى أولئك الذين لا يدركون معنىً لما يحصل أن ينصتوا له باهتمامٍ بالغ. أمّا عينا سعدي فكانتا تبكيان كثيراً، ويحجبه بريقهما المزمن سحاباً عابراً من ذكرى العراق وغنائه. إحتفاءً برموز الأدب العالمي كمثل خورخي لويس بورخيس ومحمود درويش وناظم حكمت وبابلو نيرودا وسواهم، تُعيد دار غاليمار الفرنسية، في سلسلتها الخاصة بالشعر، نشر ديوان "شمس عنكبوتيّة"1 لمحمد خير الدين (1941-1995)، وبذلك تذكِّر محيط قرّائها بهذا الكاتب المغربي، وتُتيح لهم التعرُّف من جديد على أدبه الاستثنائي داخل أزمنة الكتابة. وكتب المفكِّر جان بول ميشال، مسؤول دار ، في مقدّمة الدّيوان عن سيرة خيرالدين وروحه المجنّحة، وكيف أنّ كتابته المتجاوزة لزمنها تُظهره "بطلاً للعزلة بإزّاء الثقافات جميعاً" و"مُحاوِراً لكلّ للُّغات"، ما يجعل من المهمّ العودة إليها واكتشافها مجدّداً. ولم يكتفِ المشرف على الطبعة الجديدة، وهو ما يجب أن نحرص عليه بإزّاء أعمال كتّابٍ آخرين، بإعادة نشر الديوان كما هو في طبعته الأولى الذي ظهرت عن دار سوي عام 1969، بل أعاد ترتيب نصوصه الشعرية تبعاً لمسارها الزمني، وزاد على ذلك بأن افتتحها بمطوّلة "غثيان أسود" المعروفة التي كان الشاعر قد نشرها لأوّل مرة في كرّاس مستقل بلندن 1964، وتتكوّن من خمسة عشر مقطعاً تعبّر، في مجملها، عن شعور حادّ باليأس والتمرد، وحبّ متجذّر للأرض وأهل تربته. في ديوان "شمس عنكبوتيّة soleil arashnide "، مًضافاً إليها "غثيان أسود"، نكتشف تفكُّك القصيدة على مستوى الشكل، وذلك من خلال تناوب حاذق للأبيات والوقفات يُترجم بموسيقى الكلمات والجمل الشعرية صراع الشاعر على نحو ما يتجسدن في الصفحة الفارغة. الموسيقى، هنا، تسمح بقهر الخوف. وربّما سمحت لنا ولادة خيرالدين في فضاءٍ جنوبيٍّ معزولٍ أن نتعرَّف داخل "شمس عنكبوتيّة" على كائنٍ يُتلفه النوم ويصرخ في وجه المؤامرة بقرار اتّهام عنيف. المسار شاقّ، لكنّه مُغْرٍ يتطلّب كثيراً من النّفَس، ومن التعرُّف، قبل أن نترسّم خطّ العودة المجروح.الواقع يمَّحـي بالمسخ المدفوع إلى أقصاه، ممّا تبدو معه كائنات "شمس عنكبوتيّة" جميعها كأنّها تعبر يوم النشر. المرجع الوجودي لا يعدم علاماته الكاشفة في هذا السياق، إذا علمنا أنّ الشاعر خرج للتوّ من تجربة «أنفاس» التي لم تكن تتصوَّر الأدب خارج الالتزام. كما | |
|
Marocain-XF
عضو فريق العمل
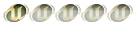

عدد الرسائل : 1913
العمر : 68
Localisation : الرباط
. : 
اوسمة العضو (ة) : 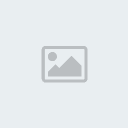
النقاط المكتسبة من طرف العضو : 8785
خاصية الشكر : 12
تاريخ التسجيل : 30/05/2009
بطاقة الشخصية
royal: 1
 |  موضوع: رد: منح الشاعر"محمود درويش جائزة الأركانة بالمغرب موضوع: رد: منح الشاعر"محمود درويش جائزة الأركانة بالمغرب  الجمعة 16 أبريل 2010, 13:21 الجمعة 16 أبريل 2010, 13:21 | |
| المرجع السوريالي لا يعدم نبرته العنيفة التي تترجم في ميكانيكيّاتها الخاصة رغبةً في التحرّر، وتوتُّراً لطبقات الهذيان والحلم، خارج الحدود المرسومة بين الشعري والسردي ومنطق الحبكة وانسجام المعنى. وهو ما نبّه إليه ألان بوسكيه بقوله إنّ مجموعة ("شمس عنكبوتيّة"... مفعمة بجيشان شافٍ، وبحاجةٍ إلى مناهضة كلّ شيء، سواء تعلّقۤ الأمر بالوضوح أم بالمواضعات الخاصّة بالأجناس¬ الأدبيّة). وممّا له دلالة هنا، أن يُؤبّن الشاعر في "رفض الدفن"، أحد نصوص المجموعة الشعرية، رائد السوريالية أندري بريتون عقب موته، بقوله: "أُحيّي هذا الحصان وهو يَهْوي من علٍ/ أندري بريتون/ مَنْ كانت به القصيدة تتدفّقُ مثل جنّيِية"2. لمّا صدرت "شمس عنكبوتيّة"، لأوّل مرة، وجدت رواية ّأغادير"، التي ظهرت قبل ذلك بعامين، قد مهّدت لها الطريق، بعد أن لا قت حفاوة في أوساط المهتمّين، ونشر موريس نادو في مجلة «الآداب الجديدة» مقتطفات من تلك الرواية الرهيبة التي كتبها خيرالدين في أعقاب الزلزال الذي دمّر المدينة عام 1960. ويمكن القول إنّ موهبته العارمة قد سبقته إلى فرنسا التي قضى بها أهمّ مراحل حياته وأخصبها خيالاً، وإن كان ذلك أتى ممزرجاً بطعم الصعق في منفى اللُّغة والوطن. وعثر، هناك، على رفقته الهائلين: جان بول سارتر، ميشال ليريس، أندري مالرو، صامويل ييكيت، ليوبولد سنغور وإيمي سيزير. ممّن آزروه ووجد فيهم عزاء الكتابة وقوّة جذبها إلى المجهول. إلى جانب "شمس عنكبوتيّة"، مجموعته الشعرية الأولى التي مُنحت جائزة الصداقة الفرنسية- العربية، صدر لمحمد خيرالدين في حياته مجموعتان أخريان: "أنا الحامض"[سوي،1970] و"إنبعاث الأزهار البرّية" [الستوكي ـ الرباط،1981]، عدا رواياته: "أغادير" [سوي، 1967]، و"جسم سالب، يليه: قصة إله طيّب"[سوي،1968] و"النبّاش" [سوي،1973] و"أسطورة أغونشيش وحياته"[سوي،1984]، وإن كان يصعب أن نجد حدوداً مرسومةً بين الشعري والسردي داخل هذه النصوص العابرة لأزمنة الكتابة، التي أدخلت "رعشة جديدة" في لغة موليير التي أبدع بها أيّما إبداع. لا أمازيغيّة ولا عربيّة. هل، لهذا السبب، يُحتفى بالكاتب المغربي محمد خيرالدين مرّاتٍ، فيما هو بيننا لا يزال مجهولاً وغير مفكَّر فيه. إنّه أغونشيش نفسه، ذلك الذي يغرق في النّوْم، ويصرخ في وجه المؤامرة بقرار اتّهام عنيف صدر الديوان الأخير للشاعر محمود درويش وعنوانه «لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي» عن دار رياض الريس التي تملك حقوق نشر أعمال الشاعر الراحل. والديوان في 154 صفحة، وقد قسم الى ثلاثة أبواب: «لاعب النرد»، «لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي» و «ليس هذا الورق الذابل إلا كلمات». أما القصائد الموزّعة في هذه الأبواب فهي إحدى وثلاثون.وأرفق الديوان بكراس خاص للروائي الياس خوري عنوانه «محمود درويش وحكاية الديوان الأخير» وفيه يروي قصة هذا الديوان وكيف وجده وأعدّه وبوّب حكاية الديوان الأخير إلياس خوريكان لقائي بمحمود درويش، ظهر ذلك اليوم من شهر أيلول ملتبساً وغريباً. ذهبت الى عمان للاشتراك في اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤسسة محمود درويش. مساء اليوم الذي سبقه التقيت بأحمد درويش والمحامي جواد بولس، الآتيين من الجليل، وبعلي حليلة ومارسيل خليفة، في باحة الفندق. علي الذي رافق، مع أكرم هنية، الشاعر في رحلته الأخيرة الى هيوستن تكساس، حيث أجريت له جراحة الشريان الأبهر التي أودت به، روى لنا الأيام الأخيرة من حياة الشاعر، وتطور الانهيار الجسدي الشامل الذي أصابه بعد الجراحة. كانت ليلة حزينة، لا أدري كيف أصفها الآن، لكنني أراها مثل منام مغطى بالبياض. لم يجعلني كلام علي حليلة أقتنع بأن محمود درويش مات، حتى عندما أضاف أكرم هنية في اليوم التالي بعض التفاصيل الصغيرة، وروى لنا أن درويش رأى في منام ليلته ما قبل الأخيرة معين بسيسو، وتساءل ماذا جاء معين يفعل هنا؟ لم أقتنع. فالموت حين يأتي يتشكل كحجاب سميك يفصل عالم الأحياء عن عالم الموتى. نتحدث عن الميت بصيغة الغائب، وننسى صوته. لكن مع درويش بدا لي الموت بعيداً. كنت أستمع الى الحكايات التي تروى، وأنا أتلفت يميناً وشمالاً، كأنني أنتظر وقع دعسات درويش في أي لحظة. لكنه لم يأتِ، تركنا نحكي عنه كما تشاء لنا الذاكرة أن نحكي، ولم يكسر دائرة كلامنا بمزاحه وملاحظاته اللامعة. في صبيحة اليوم التالي، عقدت اللجنة اجتماعها الأول بعدما انضم الينا ياسر عبد ربه وأكرم هنية وغانم زريقات وخالد الكركي وأحمد عبدالرحمن وصبيح المصري. ناقشنا مطولاً مسألة تشكيل المؤسسة، وتكلمنا عن الضريح، والحديقة التي ستقوم حوله، ومتحف الشاعر الذي سيبنى في المكان. تكلمنا في كل شيء، لكنني في الواقع كنت أنتظر نهاية الاجتماع بلهفة، كي نذهب مع علي حليلة الى بيت الشاعر في عبدون. لم يدخل أحد الى المكان منذ أن غادره درويش في رحلة موته الى أميركا. وكان على مجموعة منا أن تدخل الى البيت بحثاً عن قصائده الأخيرة. قال محمود لعدد من أصدقائه انه يملك ديواناً جديداً جاهزاً في غرفة مكتبه في منزله في عمان، وأكد ذلك ناشره رياض نجيب الريّس. فتح علي حليلة الباب ودخلنا. كان كل شيء على حاله. البيت يشبهه، أناقة من دون بذخ، وإيقاع هادئ تصنعه اللوحات المنتشرة، ومكتبة تضم كتاب العرب والعالم أمواتاً وأحياء. «لسان العرب» الى جانب ديوان التنبي، مجموعات شعرية وروايات في كل مكان، مرتبة تشير الى أنها قُرئت أو في طريقها الى ذلك. لا أدري لماذا عجزنا عن النطق، وحي تكلمنا لم تصدر عنا سوى أصوات هامسة. أحمد درويش، شقيق الشاعر جلس على الكنبة في الصالون وانفجر بكاء. مارسيل خليفة جلس الى جانبه مواسياً. دخلت مع جواد بولس الى المكتب، حيث من المفترض أن نجد الديوان. كنت أنتظر أن أجد المخطوط على سطح المكتب، لكنني لم أجد شيئاً. كنت أنتظر أن أجد رسالة تشرح لنا ماذا يجب أن نفعل بالديوان، لكن الرسالة لم تُكتب. لم يكتب محمود درويش وصية. ليلة الجراحة طلب من علي حليلة وأكرم هنية أن يبقيا معه، لأنه يريد أن يتكلم، لكنهما نصحاه بالراحة، لأن وقت الكلام سيأتي بعد نجاح العملية الجراحية! لم يكتب درويش وصية ولم يتكلم، رغم كل الأخطار التي كان يعرف أنها في انتظاره. عندما استمعت الى علي وأكرم يرويان الوحدة التي كان يشعر بها الشاعر المستلقي على سرير المستشفى الأميركي، أصبت بالقشعريرة، وشعرت بالخوف. في هذه المجموعة من القصائد، سنقرأ قصيدة عن الخوف، وندخل مع الشاعر لحظات النهاية التي يرسمها الخوف من النوم الأبدي على وجوهنا وأجسادنا. وقفنا أمام المكتب الفارغ حائرين، كنت متأكداً من وجود الديوان، لأن درويش نشر منه ثلاث قصائد في الصحف هي: «على محطة قطار سقط عن الخريطة» و «لاعب النرد» و «سيناريو جاهز»، وقرأ ثلاث قصائد غير منشورة في الأمسية الأخيرة التي أقامها في رام الله، هي: «ههنا، الآن، وههنا والآن» و «عينان» و «بالزنبق امتلأ الهواء».(...) خطر في بالي أن الديوان في الدُرج، حاولت فتحه، لكن اضطرابي أوحى لي بأن الدرج مقفل بالمفتاح، أين المفتاح، سألت؟ بحثنا عن المفتاح فلم نجده. قلت يجب أن نخلع الجارور، حين امتدت يد أحد الأصدقاء وفتحت الدرج، فانفتح بسلاسة أكوام من الأوراق. وقعت عيناي في البداية على قصيدة «طباق»، المهداة الى ادوارد سعيد، المنشورة في ديوان «كزهر اللوز أو أبعد» مكتوبة بخط اليد. من المؤكد أن درويش وضعها هنا، كي يقرأها في محاضرة إدوارد سعيد التذكارية التي تنظمها جامعة كولومبيا في نيويورك في نهاية شهر أيلول، لكن الموت جاء، معلناً الوداع النهائي «لشعر الألم». بحثنا أنا والمحامي جواد بولس شبه يائسين، وفجأة رأيت دفتر بلوك نوت ذا غطاء أزرق وضعت فيه القصائد. أولى القصائد كانت «لاعب النرد». قلبت الصفحات فعثرت على قصيدتي «عينان»، و «بالزنبق امتلأ الهواء». بحثنا في الدرج عن قصائد أخرى، فعثرنا على مسودات قصائد قديمة منشورة، لكننا لم نعثر على قصائد جديدة. رقمنا المخطوط، وصورنا منه صورتين. أعدنا الأصل الى الدرج في مكانه، وأخذ أحمد شقيق الشاعر نسخة، بينما احتفظت أنا بالنسخة الثانية. وقرّ رأي الجميع أن يُعهد لي بالقصائد، كي أعدّها للنشر، وأكتب حكايتها، على أن تصدر في 13 آذار 2009، أي في يوم عيد ميلاد الشاعر، فتكون قصائده الأخيرة هديتنا الى من أهدى العرب والفلسطينيين أجمل القصائد. أخذت القصائد الى غرفتي في الفندق، أقفلت الباب وقرأت، وشعرت بالحزن الممزوج بالعجز عن القراءة. في المساء سهرنا في حديقة منزل علي حليلة، وكانت القصائد معي، طلبوا مني أن أقرأ، فقرأت متلعثماً. كانت تلك القراءة سيئة وعاجزة، كيف أقرأ وأنا متيقن من أن درويش سيفاجئنا في أي لحظة ويسخر من وجوهنا الحزينة. لم ينقذ الليلة سوى مارسيل خليفة، أمسك بعوده وغنى الشعر الذي صار أشبه بالدموع. كانت كلمات درويش وموسيقى الروح في قصائده، تلفنا وتأخذنا اليها. كان الحزن، ولا شيء آخر. بدل أن نفرح بالديوان احتلنا شبح الغياب. الحقيقة أن المشاعر اختلطت، إذ كنا، ونحن نعمل في المنزل نشعر بالحضور السري والغريب للشاعر. في غرفتي في الفندق شعرت ان عليّ أن أعيد القصائد الى مكانها في الدّرج، غداً يأتي محمود ويقرر كيف يرتب قصائده، ويتعامل مع التعديلات التي يقترحها. قلت في نفسي إن عليّ التخلي عن هذه المهمة. نمت نوماً متقطعاً، والتبست عليّ الأمور في شكل كامل. قرأت القصائد كلها أكثر من مرة، وتأكد لي أننا لم نعثر على كلّ المجموعة الأخيرة من القصائد. لا شك في أن هناك قصيدة كبرى في مكان ما، وان اضطرابنا منعنا من اكتشاف مكان وجودها. في صباح اليوم التالي، وبينما أشرب قهوتي رن الهاتف، وسمعت صوت مارسيل خليفة يطلب مني المجيء الى منزل درويش لأن غانم زريقات عثر على القصيدة. في المنزل أخذت قصيدة طويلة بلا عنوان، مكـــتوبة بخط يد درويش في خمس وعشرين صفحة. وعلى عكس الكثـــير من القصائد التي وجدناها، فإنها ناجزة، ولا أثر فيها للتشطيب أو اقتراحات التعديل قرأت القصيدة التي قفز عنوانها من بين السطور من دون أي جهد: «لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي»، ووجدتني أمام عمل شعري كبير، قصيدة تصل بالمقترب الملحمي – الغنائي الذي صاغه درويش الى الذروة. ومعها عثرنا على خمس قصائد جديدة. في تلك اللحظة اقتنعا أننا أمام عمل شعري كبير يشكل إضافة حقيقية على الديوان الذي تركه الشاعر. قصائد لم يلق عليها نظرة الوداع ... المكان الذي أصبح طللاً في ديوان محمود درويش الأخير ديمة الشكر ديوان محمود درويش «لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي»، يصحّ فيه وصف الديوان الأخير، فالشاعر «طوى الجزيرة وجاءنا الخبر» في الصيف المنصرم قبل الصدور. في الديوان احدى وثلاثون قصيدة، تجمعها موهبة قلّ نظيرها في الشعر العربي، وتنفرد كلّ منها بخاصّة منقطعة القرين، فدرويش هو الشاعر الذي لا يستكين إلى منجزٍ مهما كان جميلاً وأصيلاً، ولا يرتاح إلى «شهرة» فيتكئ عليها، ولا يكرّر السير في دربٍ عبدّها وإن أضمرت نجاحاً وانتشاراً. فهذا الديوان لا يتصل بما سبقه إلا بقدر ما ينفصل عنه، ويستطيع القارئ الشغوف بشعر درويش أن يجد بنفسه بعض خيوط الاتصال مع دواوين سابقة، فـ الجدارية، ولا تعتذر عمّا فعلت، وكزهر اللوز أو أبعد، وأثر الفراشة، حاضرة من خلال الخيارات الفنيّة الخاصّة بدرويش، التي أتاحت له أن يطوّر شبه منفرد تيار التفعيلة برّمته، من خلالِ ابتداعه لأشكال شعريّة جديدة، فضلاً عن زيارته للقصيد في ثلاث قصائد، تخصّ أولاها الشاعر وثانيتها الشعر أمّا ثالثتها فتضمّن بيتاً شهيراً للمتنبي، وليس في هذا الأمر مفاجأة، بل صلة وثيقة مع أثر الفراشة الذي تنقّل فيه درويش بين المعقود والمنثور، وكتب فيه القصيد أيضاً (على قلبي مشيتُ، في صحبة الأشياء، ربيعٌ سريع). لكنّ حضور الأعمال السابقة على هذا النحو، لا يشغل المتن الأساس للديوان الجديد، الذي يظهرُ مفارقاً لها في غير ما أمرٍ. فمن أهمّها، أن معانيه تدور حول الغياب، لا باعتباره نتيجةً ملموسةً للموت الجسدي، بل من خلالِ توسيع معناه ليصبح موضوعاً شعرياً كبيراً، ينفذّ | |
|
Marocain-XF
عضو فريق العمل
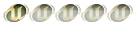

عدد الرسائل : 1913
العمر : 68
Localisation : الرباط
. : 
اوسمة العضو (ة) : 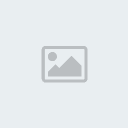
النقاط المكتسبة من طرف العضو : 8785
خاصية الشكر : 12
تاريخ التسجيل : 30/05/2009
بطاقة الشخصية
royal: 1
 |  موضوع: رد: منح الشاعر"محمود درويش جائزة الأركانة بالمغرب موضوع: رد: منح الشاعر"محمود درويش جائزة الأركانة بالمغرب  الجمعة 16 أبريل 2010, 13:23 الجمعة 16 أبريل 2010, 13:23 | |
| الشاعر منه إلى ما قبل الغياب أي الحياة، التي تعطيه معنىً شعريّاً يبدّد عبره نقيضها أي الموت، فيصحّ القول إن في غياب الشاعر حضوراً، من دون أن يقتصر الأمرُ عليه، ذلك أنّ درويش لم يكن صاحب أوهام شخصيّة تقول بالخلود أو أخته الشهرة، وهو لا يرى فيهما ما يميّزه، بل ما يسجنه في صورة رمزٍ أتعبته في الحياة، لذا جاءت قصيدته «لاعب النّرد» لكسر هذه الصورة النمطية، عبر سؤالٍ «من أنا لأقول لكم؟» لن يتأخر جوابه «أنا مثلكم أو أقلُّ قليلاً»، ويتبعه سردٌ لحياة شخصيّة، من الولادة الفردية التي ليست إلا مجموعةً من الحوادث الشخصيّة (الهرب من الذئاب، محاولة انتحار) والمصادفات، مروراً بشغفين : الحبّ «أدرّب قلبي/ على الحبّ كي يسعَ الورد والشوك»، والشّعر «لولا وقوفي على جبلٍ/ لفرحتُ بصومعة النسر: لا ضوء أعلى!»، وصولاً إلى سؤال ما قبل النهاية «من أنا لأخيّب ظنّ العدم؟»، حيثُ تتكفّل المصادفات بإعطاء «أنا الشاعر» بعداً شخصيّاً نافيّاً عنها بذلك صفةً أَسَرَته، الأنا الناطقة باسم الجماعة، بينما يؤدّي تجاور ضميري أنا ونحن في جملة واحدة، إلى توسيع حدودها لتغدو الأنا التي تحمل الجماعة في وجدانها :«من سوء حظّي أن الصليب/ هو السلّم الأزلي إلى غدنا»، وتتقنُ إصابة الشخصّي والمشترك: «كان يمكنُ ألا أكون مُصاباً/ بجنّ المعلقة الجاهليّة/... لو أن دورية الجيش لم ترَ نار القرى/ تخبز الليل/ لو أن خمسة عشر شهيداً/ أعادوا بناء المتاريس/ لو أن ذاك المكان الزراعي لم ينكسر» أو «شمألتُ شرّقتُ غرّبتُ/ أما الجنوب فكان قصيّاً عصيّاً عليّ/ لأن الجنوب بلادي». الاستعارة البعيدة للغياب مراتبه الخاصّة في الديوان، فهو الاستعارة البعيدة، إذ يغدو قريناً للمكان في قصيدتين تستلهمان الوقوف على الأطلال «على محطة قطار سقط عن الخريطة» و «طلليّة البروة»، فالأولى تخصّ فلسطين كلّها، إذ إن القطار الذي كانَ يمرّ بين بلاد الشام ومصر، واقعٌ بين المجاز والحقيقة، فالأرض التي يسيرُ فيها خاليةٌ من البشر، فيها عناصر حيّاديّة «عشبٌ، هواءٌ يابسٌ شوكٌ وصبّارٌ»، تشيرُ إلى مكانٍ محدّد ما أن تجاور مفردات أخرى تُبطن انكسار المكان عبر المجاز تارةً :«عدمٌ هناك موثّقٌ... ومطوّقٌ بنقيضه»، وعبر الحقيقة تارةً أخرى: «وقفتُ على المحطة لا لأنتظر القطار... بل لأعرف كيفَ جُنّ البحر وانكسر المكان» أو«قلنا البلاد بلادُنا/ قلبُ الخريطة لن تصاب بأيّ داءٍ خارجي...فلم نرَ الغد يسرقُ الماضي - طريدته ويرحل». وليس القبول بانكسار المكان ذريعةً للوقوف في أطلاله، بل العكس هو الصحيح، فالأرضُ التي تُعرّف بالغياب ترسم طريق استعارة كبرى للمكان: «أهذا كلّ هذا للغياب؟ وما تبقى من فتات الغيب لي؟»، وليس الغياب كاملاً سوى قرين المكان الكامل غير المكسور:«أرى مكاني كله حولي... الجمال الكامل المتكامل الكلّي في أبدِ التلال ولا أرى قناصتي»، فمن خلالِ مزجٍ متقنٍ للضعف (الغياب) بالقوة (المكان) يتعطل القبول بالانكسار. فالكلام عن الغياب هو الكلام عن المكان، يقول في القصيدة الثانية الخاصّة بقريته «طلليّة البروة»: «أختار من هذا المكان الريح/ أختار الغياب لوصفه»، إذ من خلال هذه الاستعارة الكبرى، يغدو الغياب أقوى حضوراً وأكثرَ ثباتاً، مُبطناً في الآن نفسه زوال الموقت الطارئ على المكان: «هل ترى خلف الصنوبرة القوية مصنع الألبان ذاك؟ أقول كلا لا أرى إلا الغزالة في الشباك. يقول: والطرق الحديثة هل تراها فوق أنقاض البيوت؟ أقول: كلا لا أراها لا أرى إلا الحديقة تحتها». وإن كان الوقوف على الأطلال يفتحُ باباً للغياب، ويعطّل الحاضر الذي لا يمحو الحديقة أو الغزالة من الذاكرة، فإن هذه الأخيرة لا تطوي تحت جناحها الأمسَ البعيد الذي يبُطن استعارة الغياب/ المكان فحسب، بل تطوي كذلك الأمس القريب، الذي يبطن الاستعارة ذاتها، فقصيدة «في رام الله» هي أخت قصيدة «رجل وخشف في الحديقة» من ديوان لا تعتذر عمّا فعلت، وفيها يدّقق درويش قوله عن العودة الناقصة التي لم تكن إلا لجزءٍ من المكان، من خلال سؤالٍ جارحٍ عن الخشف: «هل صارَ يألفُ بيتك؟»، إذ احتاج غالبية الفلسطينيين القاطنين اليوم في رام الله، إلى وقتٍ للألفة معها، فقلّة منهم تملك ذكريات فيها، وكأنّها صورة الفرق بين الذكرى والذاكرة أو بين المنزل والبيت، لذا يهدي درويش، سليمان النجاب قصيدة ثانيةً تشيرُ إلى الأمسِ القصير «الذكرى»: «لا أمس لي فيها سواك/ فما خرجتُ وما دخلتُ، وإنّما/ تتشابه الأوصاف كالصفصاف»، لكن هذه الإشارة اللماحة ستحملُ في طياتها صورة المكان: لي أمس فيها/ لي غيابُ!». للحبّ والشعر نصيبٌ وافرٌ في الديوان، يفترقان في قصائد ويلتئمان في أكثر من واحدة، كصنوين متلازمين كما في القصيدة الجميلة «بالزنبق امتلأ الهواء»، التي تجمع بين لحظتين تُفضيان إلى الفرح: لحظة الإلهام «بالزنبق امتلأ الهواء كأنّ موسيقى ستصدح» وانتظار موعد عاطفي «وكرسيّ يرحّب بالتي تختار إيقاعاً خصوصياً/ لساقيها. ومرآةً أمام الباب تعرفني وتألف/ وجه زائرها»، وتضمران الحياة كولادة ثانية: «أنا المعافى الآن، سيد فرصتي/ في الحبّ. لا أنسى ولا أتذّكر الماضي،/ لأني الآن أولد، هكذا من كل شيء»، فـ «كل شيء يصطفي معنى لحادثة الحياة» التي تبعدُ الموت إذ تمزج أوّل الحب بأوّل الإلهام: «بلا سبب يفيض النهر بي، وأفيض حول عواطفي: بالزنبق امتلأ الهواء كأنّ/ موسيقى ستصدح!». وإذ يتجاور الحبّ والشعر، يحضر شاعر الحبّ الشهير نزار قباني، «في بيت نزار قبّاني» الذي أنشأ لدمشق استعارة الياسمين وأدخل البيت الدمشقي جنّة الخلود الشعري: «بيتٌ من الشّعر - بيتُ الدمشقيّ/ من جرسِ الباب حتّى غطاء السرير/ كأن القصيدة سُكنى وهندسةٌ للغمام»، وإن كان درويش سيصف بيت نزار من خلال لون عينيه، فلكي نراه من خلالهما :« ليلهُ/ أزرقٌ مثل عينيه. آنية الزهور زرقاء... دمعه حين يبكي رحيل ابنه في الممرات أزرق... لم تعد الأرض في حاجة لسماء، فإن قليلاً/ من البحر في الشعر يكفي لينتشر الأزرق/ الأبدّي على الأبجديّة»، فالعينُ مرآة القلب وباب الروح كما قالت العربُ، ولعلّ هذا ما ألهم درويش إحدى أجمل غزلياته «عينان»: «عينان تائهتان في الألوان، خضراوان قبل/ العشب، زرقاوان قبل الفجر. تقتبسان/ لون الماء، ثم تصّوبان إلى البحيرة نظرةً/ عسليّة، فيصيرُ لون الماء الأخضر». وإن كانَ ظاهرُ القصيدة يصفُ تبدّل لون عيني الحبيبة بين تدرّجات الأخضر والأزرق، فإن باطنها يصفُ المزاج المرافق لكل درجةٍ لونيّة، على نحوٍ يتحدّ فيه جمال عينيها بروحها، لذا يبدو السؤال الذي يختتتم القصيدة: «عينان صافيتان، غائمتان/ صادقتان، كاذبتان عيناها. ولكن من هي؟» كمفتاحها لا قفلها. فهو سؤال فخّ، يجرّ القارئ إلى القراءة ثانيةً أو أكثر، ليكتشف أن الشاعر يعرفها بدّقة، لأن العين مرآة القلب. وتحيلُ إعادة القراءة على إطالة المتعة في قصيدة «لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي»، التي تخصّ اللقاء بين حبيبين يعاندان الفراق، ويتذكران قصّتهما، ويتحاوران في سرديّةٍ غنائيةٍ، فكلّما طال الحوار/ القصيدة طال اللقاء، وطال الاحتفاء بالحبّ صنو الحياة. لذا جاء مطلع القصيدة طارداً للموت تارةً على لسان الحبيب: «اقترب الموتُ مني قليلاً/ فقلت له: كان ليلي طويلاً/ فلا تحجب الشمس عنّي!»، وتارةً أخرى على لسان الحبيبة: «وقالت: أفي مثل هذا النهار الفتّي الوسيم/ تفكّر في تبعات القيامة؟». فالحبّ احتفاء بالحياة على صورة نهرٍ :« قالت: سيأتي إلى ليلك النهر/ حين أضمّك/ يأتي إلى ليلك النهر»، والحبّ يوّسعُ المدى، ويجعل المحبين أمراء عند اللقاء: «وأنا في ضيافة هذا النهار، أميرٌ على حصّتي/ من رصيف الخريف. وأنسى من المتكلم / فينا لفرط التشابه بين الغياب وبين/ الإياب إذا اجتمعا في نواحي الكمنجات». تتجاور في القصيدة ثلاثة معانٍ كبرى: الحبّ والحياة والشعر، وتتداخل في ما بينها: «لو لم أرَ الشمس/ شمسين بين يديك، لصدّقتُ/ أنك إحدى صفات الخيّال المروّض»، أو «ههنا يولد الحب/ والرغبة التوأمان، ونولد» أو «تقول: كأنك تكتبُ شعراً/ يقول: أتابع دورتي الدموية في لغة الشعراء»، وتستعير من الأجواء الإغريقية مشهداً هومرياً للانتظار فاللقاء بين صورتيّ أوليس وبينيلوب: «أنام وتستيقظين، فلا أنت ملتفّةٌ/ بذراعي، ولا أنا زنّار خصرك/ لن تعرفيني/ لأن الزّمان يُشيخ الصدى/ ومازلت أمشي... وأمشي/ وما زلت تنتظرين بريد المدى»، إذ يوّسع درويش من فضاء قصيدته السردية - الغنائية، عبر سرد الذكريات المشتركة لحبيبين يطول اللقاء بينهما كلّما امتدّت القصيدة، وتكون خاتمتها نفيّاً للفراق: «لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي/ لا أريد لهذا النهار الخريفي أن ينتهي»، ودافعاً لإعادة القراءة. وبعد، فهذا الديوان وإن أعطى الغياب مكانةً شعريّة رفيعةً من خلال بهاء القصائد فيه وجمالها ورفعتها، فقد أعطى درويش مكانةً أعلى من الغياب الذي «طوى الجزيرة»، فهو الشاعر الذي يصحّ فيه القول: غابَ عن العيون وبقي محصّلاً في القلوب. محمود درويش: القصيدة من دون صاحبها
الَّلهوُ الغريب مستمرّ بين الشاعر وظلالهحسين بن حمزة
ليس سهلاً على قارئ محمود درويش أن يتلقَّى ديوانه الأخير «لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي» (شركة رياض الريس للكتب والنشر). هيهات أن ننجو من فكرة أنّنا بصحبة القصيدة من دون صاحبها. لطالما كانت القراءة مسألة فردية ومزاجية بالطبع، لكنها هذه المرة ذات مذاق مختلف ومصحوب بألم الغياب. سوى ذلك، لا نجد تغيُّراً مباغتاً أو فارقاً حاسماً عما كنّا نقرأه للشاعر في أعماله الأخيرة. «الديوان الأخير» ـــــ بحسب ما جاء على الغلاف ـــــ هو استمرار للعالم الدرويشي الذي تكيَّف القارئ معه بإيعازٍ من الشاعر نفسه. انعطف صاحب «ورد أقل» أكثر من مرة. سلك دروباً جانبية. راق شعره وتصفَّى، تخفّف من الدرامية العالية، استثمر علاقات النثر، حضرت ركاكة الحياة اليومية ومهملاتها إلى جوار المجاز المعجمي العالي... لكنّه، وقرّاءه، لم يفلتوا خيط الشعر المتين الذي جمع الطرفين. نجح الشاعر في إغواء شرائح واسعة من جمهوره، القدامى منهم والجدد، على مواكبة قصيدته التي راحت تتخفَّف من حمولات سابقة وتثقل بحمولات جديدة. جدّد الشاعر شبابه الشعري وجدد ذائقة جمهوره أيضاً، إلى حد يمكن وصف ما حدث بنوع من تربية مبتكرة تلقاها هذا الجمهور، إذْ يندر أن نجد علاقة كهذه جمعت بين شاعر وجمهوره. ليس بوسعنا تجنُّب كل هذا ونحن نقرأ آخر ما كتب درويش. لا يتبدد إحساسنا بالمرارة. إذْ نعلم أن لا قصائد جديدة سوف تتلو ديوانه الأخير. نقرأ فنستعيد صداقتنا الفاتنة مع مهاراتٍ وتقنياتٍ ومعانٍ واستعاراتٍ واظب الشاعر على إشباع نهمنا لها. الموت الذي لم يتغيَّب عن أعماله الأخيرة حاضرٌ هنا. الَّلهوُ الغريب الذي جمع الشاعر مع أَجَلِهِ مستمر. الفارق أنّه مؤلم أكثر حين نقرأ ذلك بعد رحيل الطرف الأكثر هشاشةً في اللعبة. لنقرأ هذا المطلع الآسر في القصيدة التي حمل الديوان عنوانها: «يقول لها، وهما ينظران إلى وردةٍ/ تجرحُ الحائطَ: اقتربَ الموتُ مني قليلاً/ فقلتُ له: كان ليلي طويلاً/ فلا تحجب الشمس عني/ وأهديته وردةً مثل تلك/ فأدَّى تحيَّته العسكرية للغيبِ/ ثم استدار وقال:/ إذا ما أردتُكِ يوماً وجدتُك/ فاذهبْ/ ذهبتُ». في قصيدة «في بيت نزار قباني»، يتكرّر المعنى ذاته: «قلتُ له حين متنا معاً/ وعلى حدة: أنت في حاجةٍ لهواء دمشق/ فقال: سأقفز، بعد قليلٍ، لأرقد في/ حفرةٍ من سماء دمشق. فقلتُ له: انتظر/ ريثما أتعافى، لأحمل عنك الكلامَ/ الأخيرَ، انتظرني ولا تذهب الآن، لا/ تمتحنِّي ولا تَشْكُلِ الآسَ وحدك/ قال: انتظر أنت، عشْ أنت بعدي، فلا بدّ من/ شاعرٍ ينتظر/ فانتظرتُ وأرجأتُ موتي». في الحالتين، نعاين ذاك اللعب، المجازي والحقيقي، مع الموت. اللعب الذي مدَّ الشعر العربي المعاصر باحتياطيٍّ لا يُنسى من الكتابة التي خلطت الخلود الشخصي مع الخلود الشعري. أمهل الموتُ الشاعرَ أكثر من مرة. تبادل معه اللعبة ذاتها. كتَّبَهُ بعض أفضل أعماله. الخلود الحقيقي ماكثٌ في تلك الأعمال وليس في الجسد الغائب الذي ـــــ بعد كل تلك المواجهات القريبة والخطرة مع الموت ـــــ قال صاحبه: «من أنا لأخيِّب ظنَّ العدم؟» لكنه قال أيضاً: «أنا القويّ وموتي لا أكرره/ إلا مجازاً، كأنّ الموت تسليتي». في المقابل، ننتبه إلى نزعة أخرى رافقت النصّ الدرويشي في العقدين الأخيرين وهي منح القارئ فرصة التجوال في الفناء الخلفي لقصيدته. إنّها لعبة أخرى يُشركُ بها صاحب «لا تعتذر عما فعلت» القارئ في أسرار «فنّه» الشعري. «لا دور لي في القصيدة/ غير امتثالي لإيقاعها/ (...)/ لا دور لي في القصيدة إلا/ إذا انقطع الوحي/ والوحي حظُّ المهارة إذْ تجتهد». يقول في «لاعب النرد» ثم يخصص قصيدة «إلى شاعر شاب» بكاملها ليستعيد سماتٍ حقيقية، وأخرى مشتهاة، في ممارسته الشعرية مكتوبة على شكل نصائح لشاعر مستجد: «قد تسمي نضوب الفتوة نضج المهارة/ أو حكمةً/ إنها حكمةٌ، دون ريب،/ ولكنها حكمة اللاغنائية الباردة». ثمة لذة مضاعفة في كتابةٍ كهذه تسعى إلى إنجاز قصيدة، وإلى تضمين «وصفة» كتابتها فيها. الاستعارة السابقة تقودنا إلى حجم ونوعية التطوير الذي أحدثه درويش في قصيدته التي خفت صوتها العالي، وصارت أقصر وأكثف، وقلَّ فيها التنامي الدرامي والغنائي والعاطفي الذي يحدث على حساب المعنى... حتى إنّ بعض القصائد القصيرة في دواوينه الأخيرة صارت تستدرج ما راج لدى شبان قصيدة النثر في طبعتها اليومية والشفوية. من جهة أخرى، ينبغي ألا ننسى أن درويش ورِث أفضل تقاليد القصيدة العربية الكلاسيكية، وكان أبرز كتَّاب قصيدة التفعيلة. القصد أنّ مثابرة الشاعر على تطويع ما بدا عصيّاً على قصيدته لم تُخرج نبرته من صورة الشاعر كما هي في التراث العربي. إذا كان الشاعر نبيَّ جماعته ولسان حالها، فإن محمود درويش كان نبياً مماثلاً لكن من نوع معاصر. إنّه «الشاعر» بأل التعريف، وبالمعنى الذي خلَّدته الذائقة العربية في تعاطيها مع فنّ الشعر على امتداد قرون. ولهذا، لا نستغرب أن نقرأ قصائد عدّة مكتوبة بإيعازٍ من العمود الشعري العربي، كما هي الحال في قصيدة «ههنا» و«إذا كان لا بد» و«يأتي ويذهب» و«من كان يحلم».. حيث يمرِّغ الشاعر عبارته الحديثة في تفعيلات الفراهيدي المعتَّقة، تلك التي تصنع له قرابة مع أقران سبقوه في الزمن، لكنه حاول مجايلتهم في المجاز. أسماء مثل امرئ القيس وطرفة والمتنبي وأبي تمام ... ليست بعيدة في هذا السياق. ويمكن أن نُلحق قصيدة «طللية البروة» كتفصيل آخر في تَرِكة درويش الشخصية من الإرث الشعري العربي. بل إنه يقف على ما يتخيّله من مسقط رأسه المدفون تحت منشآت بناها الاحتلال الإسرائيلي على أرضها: «أقول لصاحبيَّ: قفا لكي أزن المكانَ/ وقفره بمعلقات الجاهليين الغنية بالخيول وبالرحيل/ (...)/ ويُقاطع الصحفيُّ أغنيتي الخفيّة: هل/ ترى خلف الصنوبرة القوية مصنع/ الألبان ذاك؟ أقول كلا. لا/ أرى إلا الغزالة في الشِّباكْ/ يقول: والطرق الحديثة هل تراها فوق/ أنقاض البيوت؟ أقول: كلا. لا/ أراها، لا أرى إلا الحديقة تحتها/ وأرى خيوط العنكبوت ». لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي» كتب درويش. والأرجح أنّها لن تخيِّب رجاءه. « | |
|

